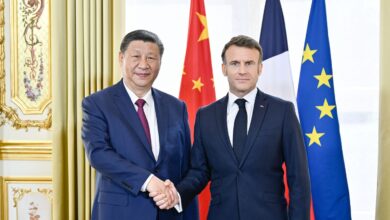“Counterpunch”: المقاومة الفلسطينية تعرقل العربة الأميركية الإسرائيلية

المؤشر 12-05-2024 نشرة “Counterpunch” تنشر مقالاً للكاتب رضا بهنام، تحدّث فيه عن تأثير التضامن العالمي مع فلسطين، وخصوصاً الطلاب الجامعيين في الولايات المتحدة، والتي لطالما دافعت عن “إسرائيل” على الرغم من المذبحة التي تنفّذها بحقّ الشعب الفلسطيني في غزة. وذكر بهنام، في مقاله، الأميركيَين راشيل كوري وآرون بوشنيل اللذين ضحّيا بنفسيهما من أجل الفلسطينيين وحقوق الإنسان.
يعرقل الطلاب الجامعيون في معظم الولايات المتحدة عربة الفصل العنصري والإبادة الجماعية الأميركية الصهيونية الجارية الآن في غزة، وفي كل أرض فلسطين التاريخية المحتلة، منذ قيام كيان الاحتلال في عام 1948.
المخططات القديمة المتجددة، هدفها السيطرة الصهيونية على كامل الأرض، كما يوضح ذلك بصورة لا لبس فيها في برنامج “حزب الليكود” في عام 1977، “بين البحر والأردن لن تكون هناك سوى السيادة الإسرائيلية”.
كل هذا دفع الطلاب الأميركيين إلى تحدّي مشروع “إسرائيل” الاستعماري الاستيطاني الوحشي، وإدانة مشاركة بلادهم في الإبادة الجماعية في غزة، والغضب من المؤسسة الرسمية الأميركية في قطاعاتها، بما فيها إدارة الجامعات التي يرتادونها ويطالبونها بفكّ كلّ أنواع شراكتها التعاونية في كل مجال مع حكومة “تل أبيب” الصهيونية.
مثيرة ومقلقة مخيمات الاعتصام والتضامن مع الفلسطينيين، لأولئك الذين يمارسون السلطة، لأنّها ترمز إلى وحدة الموقف الإنساني المقاوم ضد القمع.
عمداء الجامعات الأميركية المرموقة، مثل كولومبيا وإيموري وجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، لم يتورّعوا عن استخدام القوة والعنف لقمع المتظاهرين المطالبين بوقف إطلاق النار في غزة، وسحب جامعاتهم استثماراتها من الشركات التي لها علاقات بـ”إسرائيل”. وفي جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، تصرّف رجال الشرطة كمتظاهرين مضادين وهاجموا بعنف مخيمات الاعتصام المؤيدة للفلسطينيين.
اختبر الطلاب، بصورة مباشرة، الطبيعة القمعية للدولة عندما تريد سحق رسالة ما، وخصوصاً إذا احتوت على صرخة مظلوم. ولقد عرفوا كيف تمارس سلطات بلادهم والاحتلال الصهيوني الهيمنة في الخارج وفي الداخل، حين تستدعي الحاجة.
ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن مسيرة “توحيد اليمين” القومية البيضاء في عام 2017، بقدر ما كانت حقيرة، فإنها لم تثر الاستجابة العنيفة نفسها من السلطات والشرطة آنذاك. حينها، سار المئات من المتعصبين البيض عبر حرم جامعة فيرجينيا وهم يهتفون بشعارات نازية ومعادية للسامية. على الرغم من علمهم بالمسيرة غير المصرّح بها، فإن مسؤولي الجامعة وإنفاذ القانون اتخذوا الحد الأدنى من الإجراءات لمنع الفوضى والعنف. ولم يتم القبض إلا على عدد قليل جداً منهم، ثم أدِينَ بعضهم في وقت لاحق بتهمة الاعتداء أو السلوك غير المنضبط.
بالمقارنة، تمّ اعتقال أكثر من 2,400 متظاهر في الجامعات الأميركية في حملة الشرطة القمعية، التي بدأت مع الاعتصامات والتضامن الطلابي في جامعة كولومبيا في الـ18 من الشهر الماضي. ومن المفارقات أن بعض الطلاب من الذين اعتقلوا، والذين يدفعون 67,264 دولاراً سنوياً في مقابل الرسوم الدراسية الجامعية، اتُّهِم بـ “الاعتداء” على ممتلكات الغير.
الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي يعلن صهيونيته كلّ يوم تقريباً، لم يفاجَأ أحدٌ بردّه على الاحتجاجات الطلابية كما هو متوقّع، وغضّ النظر عن الجاني وانتقد الأميركيين بسبب احتجاجهم على الإبادة الجماعية في غزة. وفي خطابه الذي ألقاه في أول الشهر الجاري بشأن اضطرابات الحرم الجامعي، لم يذكر بايدن غزة ولم يعلّق على حملة الأرض المحروقة الإسرائيلية، مصدر “الاضطرابات”. وحين سئل عمّا إذا كانت الاحتجاجات قد أجبرته على إعادة النظر في سياساته، بفظاظة قال، “لا”.
قتلت القنابل الإسرائيلية نحو 15 ألف طفل فلسطيني ويتّمت أكثر من 19 ألفاً، حتى الآن في غزة. مع ذلك، التزم بايدن الصمت أمام هذه الفظائع. لكنّه لم يصمت حين قام المقاومون الفلسطينيون بعملية “طوفان الأقصى”، وخلال أيام هرول إلى “تل أبيب” لعناق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتقديم الولاء والالتزام بحماية “دولة” الاحتلال الصهيوني.
الفارق بين الأمس واليوم كبير جداً، فلقد تمكّنت حركة التضامن الواسعة مع الفلسطينيين داخل الجامعات وخارجها أخيراً من سرد ومشاركة القصة الحقيقية لفلسطين أمام الرأي العام الأميركي، الذي ضلّل على مدى 8 عقود بسردية لا تمت إلى الحقيقة بصلة، مع تجريم كلّ اختلاف بالرأي مع هذه الأكاذيب ونعته بمعاداة السامية لإخفاء قصة الضحية الفلسطيني وتغطية الجريمة الصهيونية.
ولأنه يفقد السيطرة على روايته المختلقة، يتطلع النظام الصهيوني إلى أصحاب المصلحة في الولايات المتحدة والغرب لقمع الرسالة والرسل في محاولة يائسة لقمع الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين المتزايدة. وفي الشهر الفائت، دعا نتنياهو علناً المسؤولين الأميركيين إلى استخدام قوة أكبر لقمع المتظاهرين الأميركيين، الذين قارنهم بالنازيين ووصفهم بأنهم “غوغاء من معادي السامية”.
لقد استجاب المدافعون عن “إسرائيل” في الجامعات الأميركية والحكومة ووسائل الإعلام لنداء نتنياهو، وشرعوا في استخدام قواعد اللعبة الإسرائيلية التي تعود إلى عقود بشأن كيفية تشويه سمعة المعارضة، وتبرير العنف وصرف الانتباه عن الرسالة من الاحتجاجات، وقد أغرقوا مطالب المتظاهرين من خلال تصويرهم زوراً على أنهم معادون للسامية، ويشكّلون تهديداً للسلامة، وغير مطلعين، وأنهم مخترقون من جانب محرّضين خارجيين.
إنّ أحداث الأشهر الستة الماضية توضح تماماً أنّ الولايات المتحدة لا يمكن أن تكون وسيطاً نزيهاً عندما يتعلق الأمر بالنظام الصهيوني. ومن الأمثلة على ذلك، رد فعل الولايات المتحدة على التقارير الأخيرة، التي تفيد بأنّ المحكمة الجنائية الدولية قد تصدر مذكرات اعتقال بحق كبار المسؤولين في “جيش” الاحتلال والسلطة، بينهم نتنياهو، بسبب الجرائم التي يرتكبونها في غزة. قلق نتنياهو ظهر إلى حد تحذير البيت الأبيض من أنّه إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال، فإنّه سيتخذ إجراءات انتقامية ضد السلطة الفلسطينية، لأنّها مع منظمات حقوقية فلسطينية قدّمت قضيتها المتعلقة بجرائم الحرب الإسرائيلية في غزة إلى المحكمة في عام 2021.
كذلك، يضغط عدد من الصهاينة من أعضاء الكونغرس الأميركي من “الديمقراطيين” و”الجمهوريين”، على المحكمة الجنائية الدولية لعدم التحرّك، وهدّدوا بالانتقام وصياغة تشريعات ضدها إذا مضت في محاكمة جرائم “إسرائيل”.
وكان الرئيس بايدن قال إنّ “الولايات المتحدة لا تدعم تحقيق المحكمة الجنائية الدولية”، وادعى كذباً أنّ المحكمة ليس لها اختصاص في هذه القضية، محاولاً إخفاء تواطؤ الولايات المتحدة في جرائم الحرب الإسرائيلية، والتي تمكّن المحكمة من إصدار مذكرات اعتقال بحق القادة السياسيين والدبلوماسيين والعسكريين الأميركيين أيضاً.
على الرغم من أنّ الولايات المتحدة ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، التي تأسست في مدينة لاهاي، جنوبي هولندا في عام 2002، لمحاكمة مجرمي الحرب، إلّا أنها حرصت على حماية نفسها وحلفائها من الملاحقات القضائية المحتملة في جرائم شتى.
حينها، أقر الكونغرس الأميركي في عهد الرئيس جورج دبليو بوش قانون حماية الجنود الأميركيين، تحت اسم “قانون غزو لاهاي”، الذي يسمح للرئيس أن يأمر الجيش الأميركي بـ”إنقاذ” المسؤولين والعسكريين الأميركيين ومن الحلفاء، في مقدمتهم “الدولة” الصهيونية من الاحتجاز بقرار الجنائية الدولية.
في الدفاع عن “الدولة” الصهيونية، كانت الولايات المتحدة، ولا تزال، على استعداد لانتهاك قوانينها الخاصة والقوانين الدولية على حد سواء. فقانون مراقبة تصدير الأسلحة وقانون المساعدة الخارجية، على سبيل المثال، يحددان أحكاماً تنظّم المبيعات العسكرية للمستهلكين الأجانب والحكومات الأجنبية. وهو يحظر، في بعض بنوده، المساعدة الأمنية “لأي دولة تشارك حكومتها في نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دولياً”. لكن، على الرغم من الهجوم الإسرائيلي الوحشي في غزة والضفة الغربية المحتلة، فإنها تستمر في تقديم المساعدات العسكرية غير المشروطة إلى “دولة” الاحتلال.
لقد شوّهت هذه الممارسات ما تبقّى من مكانة الولايات المتحدة الدولية. وفي محاولة إضافية لإرضاء اللوبي المؤيد للدولة الصهيونية، وإسكات الانتقادات لها والحد من الاحتجاجات والمظاهرات، أقرّ الكونغرس، في الشهر الماضي، “قانون التوعية بمعاداة السامية”، على نحو يوسّع التعريف القانوني لها ليشمل “استهداف “دولة” الاحتلال وتحديدها على أنّها جماعة يهودية”. إذا تم التوقيع عليه ليصبح قانوناً، فإن معارضة الصهيونية وانتقاد “إسرائيل” سيُعَدّان معاداة للسامية.
وفقاً لـ 320 عضواً في مجلس النواب صوّتوا لمصلحة القانون المذكور ومعارضة 91 عضواً، فإنّ “إسرائيل” وحدها فوق النقد. إضافة إلى ذلك، فإنّ التشريع المقترح ينتهك الحق في حرية التعبير، المنصوص عليه في التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة.
هذا النوع من القوانين التحريضية يقدّس “الدولة” العنصرية الإسرائيلية، ليبرّر دعمه، سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، والإعفاء من المحاسبة، لتنفيذ الإبادة الجماعية اليوم في غزة من دون عوائق.
تاريخ طويل للولايات المتحدة في توفير الغفران والتغطية على جرائم “إسرائيل” ضد الإنسانية في فلسطين. ومنذ عام 1972 حتى اليوم، استخدمت حق النقض 53 مرة في مجلس الأمن ضد القرارات أو الإدانات الدولية التي تنتقد “إسرائيل”. وفي أحدث خطوة اتخذتها واشنطن لتبديد آمال الفلسطينيين في تقرير المصير، استخدمت الولايات المتحدة، في الشهر الماضي، حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن الذي يوصي بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة. وفعلت الإدارة ذلك في الوقت الذي أعلنت أنها تبذل جهوداً دبلوماسية لإقامة دولة فلسطينية عندما تنتهي المذبحة في غزة.
المتظاهرون والمحتجون داخل حرم الجامعات الأميركية وخارجها يدركون أنّه لا يمكن أن يكون هناك عمل كالمعتاد إذا ما استمرت الإبادة الجماعية في غزة، لكن المؤسسة الحاكمة والدولة العميقة تمارس ضغوطاً للحد من تأثيرهم، باعتقاد كما لو أنّ “إسرائيل” في شكلها الحالي، لها مستقبل في الشرق الأوسط.
يدرك أنصار “فلسطين الحرة” أنّ نشاطاتهم قد تأتي عليهم بتكلفة اقتصادية وبـ”سجل” لدى الشرطة، لكنهم لا يتراجعون عن موقفهم، إنسانياً وسياسياً. راشيل كوري واحدة من هؤلاء. طالبة جامعية تبلغ من العمر 23 عاماً من أولمبيا سحقتها جرافة تابعة “للجيش” الصهيوني حتى الموت في أثناء محاولتها منع هدم منزل فلسطيني في رفح في عام 2003.
لكن إرث كوري في فلسطين اليوم، وقد سمّت العشرات من العائلات الفلسطينية بناتها على اسمها، وزرعت أشجار الزيتون باسمها أيضاً، وكلية “إيفرغرين” الحكومية، حيث كانت كوري تدرس هي أول جامعة أميركية تسحب استثماراتها بالكامل من “دولة” الاحتلال.
كان آرون بوشنيل، وهو عضو في الخدمة الفعلية في سلاح الجو الأميركي، يبلغ من العمر 25 عاماً عندما أضرم النار في نفسه في 25 شباط/فبراير 2024 خارج السفارة الإسرائيلية في واشنطن العاصمة. كانت كلماته الأخيرة عندما التهمته النار: “فلسطين حرّة”.
قبل أن يضرم بوشنيل النار في نفسه، قال: “أنا على وشك الانخراط في عمل احتجاجي متطرف. لكن بالمقارنة مع ما يعيشه الناس في فلسطين على أيدي مستعمريهم، فهو ليس متطرفاً على الإطلاق. لكن قرّرت طبقتنا الحاكمة أنّه طبيعي”.
في الـ10 من آذار/مارس الماضي أعلن مسؤولون في مدينة أريحا الفلسطينية تكريمه، عبر إطلاق اسم آرون بوشنيل على شارع في المدينة، كما كرّموا راشيل كوري بالمثل في رام الله في الضفة الغربية.